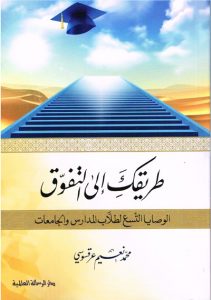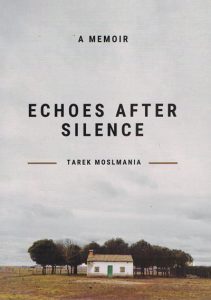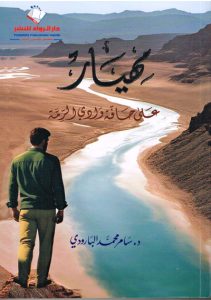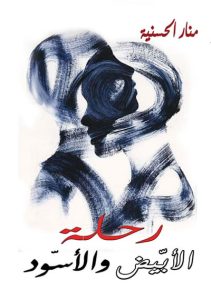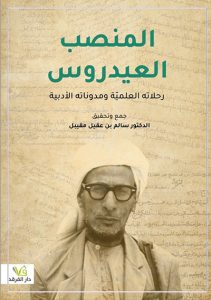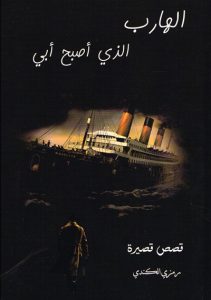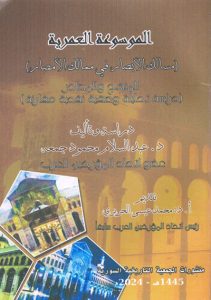سقا الله أيام زمان؛ يوم كان الكتاب يتنقل بين عواصم العالم العربي؛ لا يخاف دَرَكاً، ولا يخشى.. يبحث رجل الجمارك في حقيبة المسافر عن كل شيء، فإن وقعت يده على كتابٍ نحاها عنه بكل احترامٍ.. يومها كان الحرف يحظى بقداسة تجلُّه أن يقع على الأرض، وكان للكلمة سحرها وفاعليتها.
سقا الله أيام زمان؛ يوم كان الكتاب يتنقل بين عواصم العالم العربي؛ لا يخاف دَرَكاً، ولا يخشى.. يبحث رجل الجمارك في حقيبة المسافر عن كل شيء، فإن وقعت يده على كتابٍ نحاها عنه بكل احترامٍ.. يومها كان الحرف يحظى بقداسة تجلُّه أن يقع على الأرض، وكان للكلمة سحرها وفاعليتها.
لم تنج الكلمة من سيف الرقابة المسلَط يوماً.. منذ أيام العرب الأولى في سوق عكاظ، حيث كان الشعراء ينشدون أشعارهم، وكان النقاد لهم بالمرصاد يسلقونهم بألسنة حداد، مروراً بالمتنبي كبير شعراء العصر الإسلامي الذي ألَّفوا في نقده وسرقاته ومشكل شعره كتباً. وانتهاءً بسفّود الرافعي الذي شوى العقاد به على النار، وبرسالة الزيات التي كنا نتتبع عبرها المعارك الأدبية المحتدمة بين كبار الأدباء أواسط القرن الماضي؛ نتفاعل معها ونشارك فيها شجباً وتأييداً.. ثم خبا بعد ذلك كل شيء: هدأت المعارك الأدبية، وخفتت أصوات النقد، وسادت ثقافة البعد الواحد، واللون الواحد؛ لينشأ في ظلهما جيل الاسترخاء الفكري والعزوف القرائي والتواكل.
الرقابة كانت وما تزال حاضرة في كل زمان ومكان، ولكن شتان بين رقابة يديرها المجتمع في العلن وعلى رؤوس الأشهاد، ورقابة تتولاها السلطة في الخفاء داخل الدهاليز المغلقة، وإن بين الرقابتين لبوناً شاسعاً في الشكل والآليات من جهة، وفي المضمون والحصاد من جهة ثانية.
فبالإضافة إلى فرق السر والعلن، ثمة فروق جوهرية بينهما، أرجو ألا أملكم بسردها:
● ففي ظل رقابة المجتمع يتحمل صانعا الكلمة؛ المؤلف والناشر، مسؤوليتها على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ويستعدان لتلقي ردود الأفعال المتباينة حولها وتلك هي – لعمري- رقابة الذات.
وفي ظل رقابة السلطة، يرفع صانعا الكلمة مسؤوليتها عن عاتقهما، ويلقيان بها على عاتق الرقيب، ويعفيان نفسيهما من تلقي ردود الأفعال، ومن تبعات القيل والقال، فتغيب رقابة الذات لتحل محلها ثقافة الإملاء.
● رقابة المجتمع لاحقة تسمح للكتاب أن يختزل الوقت، ويتابع التطورات والأحداث.
ورقابة السلطة سابقة، تضع الكتاب على قائمة الانتظار التي قد تذهب بألقه ومناسبته وجدواه عند صدوره.
● رقابة المجتمع تعددية: تتناوله من وجهات نظر مختلفة، بين مبارك متفق ومعارض مختلف؛ يحتدم النقاش بينهما بقدر ما ينطوي عليه الكتاب من مفاجآت، تخرج به عن الفكر السائد والمسلَّمات.
ورقابة السلطة أحادية وصائية، ذات بعد واحد لا يثير جدلاً، ولا يحرك ساكناً.
● رقابة المجتمع هي المناخ الملائم لتعزيز القراءة، بما تشيعه من ترقب وتفاعل وتشارك وحوار ونقد بين صانعي الكلمة ومتلقيها.
ورقابة السلطة: وصائية تفترض قصور القارئ وعجزه عن تمييز الخطأ من الصواب، فتحجر عليه وتحرمه من حقه في الاطلاع، والاستمتاع بتنحية الغث والاحتفاظ بالسمين، مثلما يستمتع مقتطف الورود تدمى يداه بأشواكها، فتقدم له زاده الثقافي وجبة جاهزة منمطة مثل وجبات (ماكدونالد).
● ورقابة المجتمع معين لا ينضب؛ مفتوحة لكل هاوٍ ومحترف، بعدد غير محدود.
ولن تستطيع السلطة أن توظف لرقابتها غير عدد محدود مغلق من الرقباء يُدخل الإنتاج الثقافي- الذي يفترض أن يكون غزيراً -بهم في عنق زجاجة.
● ووفرة النقاد في المجتمع تجعل بعضهم يدعم بعضاًَ، فيعوِّض ذوو البصر النافذ فيهم، ضحالة السطحيين، فيما يشبه تدرج محاكم البداية فالاستئناف والتمييز، الذي يمنح القضية سائر الفرص حتى يخرج الحكم النهائي المبرم ناضجاً معللاً مقنعاً للجميع.
وحكم رقيب السلطة الأحادي يصدر قطيعاً مبرماً منذ الدرجة الأولى؛ غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، وغير معلَّل بما يطمئن إلى حصافة الرقيب.
● وإذا كان المجتمع قادراً على توفير العدد غير المحدود من المتطوعين ذوي الاختصاص العلمي والفني، لنقد أي عمل إبداعي، فإن ذلك متعذر على رقابة السلطة ذات العدد المحدود من الموظفين.
● لن أسترسل في عرض النتائج المتباينة لكل من الرقابتين فلديَّ منها الكثير.. يكفي أن أؤكد ما أثبتته التجربة من أن مناهج الوجبات الجاهزة والثقافة الإلزامية المنمّطة ، إنْ في المقررات التعليمية أو في الكتب الثقافية، قد بغضت الكتاب إلى الطالب والقارئ معاً، وأفقدتهما الاحترام والقداسة له، وأسهمت في إنتاج جيل مسطَّح، لم يفلت منه إلا من نأى بنفسه عنها بقدراته الذاتية وعشقه للعلم ونهمه للمطالعة.
لا تختلف الرقابة على المطبوعات في سورية عن نظيراتها في معظم بلدان الوطن العربي، إلا في درجة التشدد الرقابي، وزاوية النظر، وعلى الرغم من أنها تقع في الوسط من حيث التشدد، وإفساح بعض المجال للرأي المخالف، فقد أخذت تتخفف تدريجاً من كليهما.
ولا يزال على الناشر في سورية، حين يزمع نشر كتاب أن يعرضه قبل الطبع على مديرية الرقابة في وزارة الإعلام، وأن ينتظر رأيها فيه وحكمها عليه، الذي قد يتراوح بين السماح المطلق، أو المشروط ببعض الحذف، وبين المنع الكلي. ويستغرق انتظاره في المعدل المتوسط شهراً واحداً، وقد يتعدى ذلك إلى بضعة أشهر، خاصة إذا كان عنوانه مثيراً؛ مثل عنوان (خوف لا ينتهي)، على الرغم من أن مضمونه لا يخيف أحداً.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات الرقابية تعيق حركة النشر في عصر يتسارع فيه توليد الأفكار ونشرها، وتفقد فيه بعض المطبوعات قيمتها العلمية أو مناسبتها السياسية أو الاجتماعية قبل أن تغادر المطبعة وتصل إلى يد القارئ، فإن الناشر ما يزال يركن إليها ويألفها، ويفضلها على حرية النشر التي قد تعرضه لتحمل مسؤوليته عن الكلمة؛ سواءً أكانت مسؤولية سياسية أو اجتماعية أو دينية. ولئن كان تذرعه بموافقة الرقابة المسبقة، قد يخفف من مسؤوليته، لكنه لن يعفيه منها، خاصة إذا ارتدت المسؤولية العباءة الأمنية.
على أية حال فإن مشكلة الرقابة المحلية، ربما كانت هي الأهون على الناشر العربي، فإذا ما تجاوزها، وطبع الكتاب ونشره في بلده، فإن عليه أن يحصل له على موافقات بعدد دول الجامعة العربية إلا قليلاً ممن أراح نفسه من عبء الرقابة المسبقة، لكلٍّ منها مزاجه ومعاييره وآلياته الخاصة به لممارسة هوايته في مراقبة المطبوعات الواردة إليه، وهي مدانة كلها مسبقاً حتى تثبت براءتها، وإثبات البراءة- فضلاً عن الزمن الطويل الذي يستغرقه- سيكون متعذراً جداً في بلدان متباينة الأنظمة والاتجاهات، ويندر جداً أن ينجو كتاب من منع هنا أو حجر هناك، فإذا ما فتح له باب في بلد، أوصدت دونه أبواب في بلدان أخرى بذرائع شتى. والضحية دائماً هو القارئ المحروم من حقه في الاطلاع، ومن ورائه الثقافة العربية المحرومة من حقها في الإبداع، إذ الإبداع لا يزكو إلا في مناخ التعدد، وحرية التعبير، واحتكاك الأفكار، وتصادم الآراء،واحتدام النقد، أما الثقافة الأحادية المنكفئة على نفسها، المتقوقعة على ذاتها، فإنها عقيم لا تنجب.
إن على الناشرين – في سورية والوطن العربي- أن يناضلوا- فرادى وجماعات عبر اتحاداتهم- من أجل حرية التعبير، وحرية النشر، وحرية مرور الأفكار.. من أجل أن يتحرك الكتاب بلا حدود ولا قيود.
وعليهم أن يمتلكوا الشجاعة لتحمل مسؤولية الكلمة التي ينشرونها، تجاه المجتمع والدولة؛ مسؤولية يخترقون بها كل أطر الآبائية والماضوية والتقليدية والسكونية ليعيدوا للثقافة العربية الإسلامية حراكها وفعاليتها وقدرتها على العطاء والنماء.
في عصر المعلومات وثورة الاتصالات التي نعيش، أفلتت الكلمة من سلاسل الرقيب، وانطلقت حرةً تصل إلى الإنسان في كل مكان، وتنهمر عليه من السماء عبر الفضائيات، وتنبع بين يديه في الأرض عبر الشبكات.. لم يعد الإنسان أسير الكلمة الواحدة والخطاب الواحد والرأي الواحد، فقد تعددت أمامه الخيارات إلى درجة الطوفان، وعليه أن يتقن السباحة في خضم المعلومات ليطفو على السطح ظافراً بخيراتها ناجياً من أحاييلها وآثامها.
لم يعد للرقابة معنى في عصر المعلومات، ولن تجديها وصايتها نفعاً، إذا لم تكن مسؤولية الكلمة التزاماً مشتركاً يضطلع بها الكاتب والناشر والقارئ جميعاً.
إن المسؤول عن الكلمة أولاً وأخيراً في نظري هو القارئ؛ يوعيه الناقد، وحسه الثقافي المرهف، يستطيع أن يوجه حركة الفكر والنشر؛ بإقباله على الإبداع المميز والإنتاج الثقافي النافع، يمكنه أن يصحح المسار، ويتجاوز الغثاء، وينحي الأفكار القاتلة، ويدفن الأفكار الميتة.
لا أخاف على القارئ النهم من الضلال، فنهمه للقراءة وتوقه للاطلاع سوف يهديانه إلى سواء السبيل، فالقراءة الواعية تصحح أخطاءها.
إنما الخوف الكبير على القارئ أن يحيد عن درب القراءة، وتتراخى يده عن الكتاب، فتلك هي الطامة الكبرى..
وأخلص إلى القول:
إن الالتزام الطوعي الذي توفره رقابة المجتمع أجدى على الثقافة وأكثر مصداقية من الإلزام السلطوي الذي فقد جدواه ومعناه؛ في عصر التفجر المعرفي الذي أحدثته ثورتا المعلومات والاتصالات، فحطمت به كل السدود والقيود والوصايات.
هذا وقد افتتح السيد الدكتور علي أبو زيد معاون وزير التعليم العالي الندوة بقوله :
إن حرية التعبير لا تعني التشهير و لا تعني الشتم كما في حرية التعبير في البلدان الغربية كما فهمت و صوغت على أنهما حرية لشتم و سب نبينا محمد النبي الذي يؤمن به أكثر من مليار و أربعمئة مليون نسمة قي شتى بقاع الأرض.
و هنا نفهم بأن حرية التعبير حرية مسؤولة لها ثوابتها و ضوابطها الأساسية و تكون الحرية مسبقة دائماً للمسؤولية التي من حدها أن توقف أي شخص يعتقد بأن الحرية في الشتم و السب و التشهير دون معرفة مسبقة بأن الحرية هي حرية مسؤولة توقف صاحب الكلمة إذا أخطأ أو تجاوز.
و قد قال السيد مصطفى مقداد نائب رئيس اتحاد الصحفيين :
حرية الرأي و التعبير هما عنصران من العناصر الرئيسية لحرية الإعلام الهادف, وقد دعمت الأونروا الأسس الأخلاقية و الحقوقية و القانونية للالتزام بحرية الرأي على المستوى الدولي و التي انعكس إيجاباً على دساتير الدول جميعها دون استثناء و في الاجتماع الأول للجمعية العمومية قرروا أن حرية المعلومات هي حق أساسي للإعلان و حجر الزاوية لجميع الحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم جميعها (القرار رقم 49 ).
و قد أكد السيد مصطفى مقداد على أنه لكل شخص الحق في حرية التعبير و حرية الرأي و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الأديان دون أي تدخل . و استقدام الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وقال أيضاً أن المسؤولية عاملاً متقدما على الحرية الشخصية إذ أن تلك الأحكام لا يمكن الحكم عليها بشكل قطعي و هي تخضع لظروف الزمان و المكان و الثقافة و الرأي العام و أن عدم القدرة فهم منطق الحقوقية في الاختلاف يحرم الفرد منا أحياناً من معرفة مجاهل الغد.
محمد عدنان سالم